مقاله ای به عربی در باره شهر زیبای حلب
|
أضع بين أيديكم تقريراً عن مدينة حلب خلافاً للمعتاد. فإن المعلومات المقدمة محدودة بمصادر الكتاب الإيرانيين. فحري بنا أن نرى صورة هذه المدينة في مرآة الأقوام والثقافات الأخرى بالإضافة إلى الكتب والتقارير الكثيرة التي كتبها الكتّاب العرب على مرّ التاريخ حول حلب وخصائصها وميزاتها. إنّ المصادر المعتمدة في هذه المدونة متنوعة فهي مستقاة من مصادر تاريخية وجغرافية وكتب الرحلات ومن الشعر والنثر أيضاً. ما يقدم في هذه المقالة لا يضم كل ما كتب ولكنه يحتوي على نبذة منها. إن دراسة انعكاس العناصر الثقافية لقوم ما أو مكان ما في آثار الأقوام والملل الأخرى من الأبحاث المهمة في الدراسات الثقافية. ولبلاد الشام بمدنها الجميلة وعلى رأسها حلب مكانة ممتازة في العالم الإسلامي لا تدانيها أية مدن أخرى مرتبة. هذه البلاد ملتقى الأقوام والأديان المنتشرة والثقافات المتعددة وبتعبير آخر هي مرج البحرين شرقيّ وغربيّ العالم. ودائماً كانت هذه المدينة تتمتع بأهمية ثقافية وسياسية خاصة قبل وبعد الإسلام وظهرت حضارات كبيرة وكثيرة على تراب هذه البلاد حيث نستطيع القول حقيقة إنها كانت بلاداً مفرزة للحضارات ومولدة لها. صحيح أن دور حلب السياسي والعسكري في تاريخ بلاد الشام مهم وحيوي لكن دورها الحضاري وأرضياتها الثقافية أكثر أهمية وتلألؤاً، فالمدونات التي وصلتنا عن الرحالة والمؤرخين تصف لنا عظمة وجلال هذه المدينة من جوانبها المتعددة المتمثلة. بالمساجد والمعابد والمدارس والمشاهد والمقامات والقلاع والحصون والعمارات الجميلة كما يبهجنا ذوق أهلها وفنّهم بحيث لو كان قارئ هذه الآثار في أدنى الأرض لأحب أن يمتلك جناحين ويطير بهما ليرى عن قرب هذه المدينة ويقيم فيها. حلب ليست مدينة وحسب بل مجموعة ثقافية وحضارية. أسواقها ليست أسواق بيع وشراء وحسب بل مع وجود آثار أخرى كالقلعة والحمامات التاريخية والمساجد والمعابد تجعلها تشتمل على مجموعة ثقافية بالقرب منها تضفي عليها جمالاً متألقاً. لقد جاء وصف حلب في أقدم الآثار الفارسية حيث سنقوم بتعريف بعض منها ومدونات كتابها ومؤلفيها. 1 ـ تاريخ كزيده (التاريخ المختصر) تأليف حمد الله مستوفي ألّف هذا الكتاب في عام 730 هجرية ولحمد الله مستوفي كتب أخرى من بينها: ظفر نامه حيث كتبها عام 735ه ونزهة القلوب في الجغرافيا التي دونها عام 740ه. قبر المستوفي في مدينة قزوين وقد قام بذكر حلب في مناسبة تاريخية ويبدو أن الأسطر التالية مهمة من الناحية التاريخية: "أصبح كشتاسب بن لهراسب بن اروند شاه بن كيقباد ملك إيران في مدينة حلب، زردشت دعى في زمانه لدين المجوسية. داخل كشتاسب في الدين المجوسية والزم الإيرانيين باختيار المجوسية وأرسل إلى الروم ليدخلوا في ديانة المجوسية لكنّ الروميين أظهروا عهد فريدون المشتمل على عدم التعرض للروم مهما كان الدين الذي اختاروا. فقال كشتاسب: إن الامتثال لأوامر جدي أولى، فتركهم ([1]). 2ـ حدود العالم من المشرق إلى المغرب كتاب في وصف البلاد والتقسيمات والأقوام المختلفة وأحوالهم ألف عام 372 للهجرة في زمن محمد بن أحمد فريغون من آل فريغون المعاصر لنوح بن منصور الساماني في خراسان. مؤلفه غير معروف. ([2]) يوجد في وصف حلب في هذا الكتاب ما يلي: "حلب مدينة كبيرة من الشام، عامرة وفيها سكان كثر ومليئة بالثروات. لها سور عريض يمكن الفارس من العبور عليه." ([3]) 3 ـ آثار البلاد وأخبار العباد وهو من تأليف زكريا بن محمد القزويني في الجغرافيا والتاريخ. تم تأليف هذا الكتاب ما بين سنة 630 ـ 674 هجرية ويعدّ من أهم المصادر. يقول القزويني: "حلب مدينة عظيمة كثيرة الخيرات طيبة الهواء صحيحة التربة لها سور حصين وقلعة حصينة. قال الزجاجي: كان الخليل عليه السلام يحلب غنمه بها ويتصدق بلبنها يوم الجمعة فيقول الفقراء: حلب. فسميت بذلك. ولقد خص الله تعالى هذه المدينة ببركة عظيمة من حيث يزرع في أرضها القطن والسمسم والبطيخ والخيار والدخن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذيا يسقى بماء المطر فيأتيّ غضّاً روياً يفوق ما يسقى بالسيح في غيرها من البلاد. قال كشاجم:
والمدينة مسوّرة بالحجر الأسود، وفي جانب السور قلعة حصينة لأن المدينة في وطاء من الأرض وفي وسطها جبل مدوّر مهندم والقلعة عليه. ولها خندق عظيم وصل حفره إلى الماء. وفي وسطه مصانع للماء المعين وجامع وبساتين وميدان ودور كثيرة وفيها مقامان للخليل عليه السلام، يزاران إلى الآن، فيها مغارة كان يجمع الخليل فيها غنمه، وفي المدينة مدارس ومشاهد وبِيَع وأهلها سنية وشيعية. وبها حجر بظاهر باب اليهود على الطريق، ينذر له ويصبّ عليه الماورد المسلمون واليهود والنصارى. يقولون: تحته قبر نبي من الأنبياء. وفي مدرسة الحلاوي حجر على طرف بركتها كأنه سرير، ووسطه منقور قليلاً يعتقد الفرنج فيه اعتقاداً عظيماً، وبذلوا فيه أموالاً. ومن عجائبها سوق الزجاج، فإن الإنسان إذا اجتازها لا يريد أن يفارقها لكثرة ما يرى فيها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد التحف والهدايا وكذلك سوق المزوّقين ففيها آلات عجيبة مزوّقة." ([4]) 4ـ سفرنامه (كتاب الرحلات) لناصر خسرو (394 ـ 481 هجري) هو من أشهر الشعراء والكتاب في إيران. في عام 437 شاهد مناماً وعلى حد زعمه صحا من نوم عميق دام أربعين سنة فترك الأعمال الديوانية وقام بالأسفار الأنفسية والآفاقية وقد زار الحجاز وآسيا الصغرى وسورية ومصر وارتبط بالإسماعيليين والفاطميين في مصر. وأصبح على مذهبهم ومن دعاتهم الأشداء ولقب (بحجة) خراسان. وقد ألّف رسالته المشهورة بعد عودته من سفره الذي دام سبع سنين. كان لديه دقة وافرة في وصف مشاهداته عن المدن التي زارها. وله ديوان أشعار (قصائد) وآثار أخرى. ([5]) "جئنا يوم السبت في شهر رجب عام ثمان وثلاثين وأربعمائة إلى المروج وعبرنا في اليوم الثاني من الفرات ووصلنا إلى منبج. وتلك هي أول مدينة من مدن الشام. كان أول شهر بهمن القديم وكان جوّها رائعاً جداً لم يكن هناك أي عمارة خارج المدينة. لها حصن عظيم، قست ارتفاعه فكان حوالي خمسة وعشرين أرشاً، وفيها قلعة عظيمة تعادل عدة أضعاف قلعة بَلْخ. هي مدينة عامرة وأبنيتها تقع فوق بعضها بعضاً. ولها موقع استراتيجي بين هذه البلدان: الشام والروم وديار بكر ومصر والعراق ويأتي من كل هذه البلدان التجار إليها ولها أربعة أبواب: باب اليهود وباب الله وباب الجنان وباب أنطاكية. ومن هناك إذا اتجهت نحو الجنوب ستجد مدينة حماة على بعد عشرين فرسخاً وبعدها حمص ودمشق على بعد خمسين فرسخاً عن حلب ومن حلب حتى أنطاكية اثنا عشر فرسخاً ولطرابلس المقدار نفسه ويقال إن مئتي فرسخ للقسطنطنية هناك. وخرجنا في الحادي عشر من رجب من مدينة حلب." ([6]) 5ـ كلستان (روضة الورد) من الآثار المعروفة للشيخ مشرف الدين عبد الله الشيرازي المشهور بالسعدي الشاعر والكاتب الكبير في القرن السابع الهجري. مهارته الأساسية تبدو في الغزل وهو في هذا الشأن لا نظير له وقد أوصل كتابه البديع ـ كلستان ـ النثر الفارسي وكتابة المقامات إلى أوجه. وقد تتبع أساطين اللغة الفارسية شعر سعدي ونثره حتى زماننا هذا. كان له أسفار كثيرة ومن بينها إقامته في الشام وحلب لعدة سنوات كما قام بنقل تجاربه ومشاهداته عن الشام في كلستان. وكان معتكفاً بجانب صريح سيدنا يحيى ـ عليه السلام ـ في الجامع الأموي حسب ما نقله في كلستان. ويدون سعدي في الباب الثالث من كلستان حول فضيلة القناعة خاطرةً، يشير في خلالها إلى سوق البزازين في حلب ويقول: "كان سائل مغربي ينادي بسوق البزازين بحلب: يا أرباب النعمة لو أنكم كنتم منصفين وكنا قانعين لارتفع رسم السؤال من الدنيا" ([7]). وفي قصة جميلة أخرى في ذم الطمع والحرص لدى أحد التجار يشير إلى المرايا الحلبية المعروفة التي كان لها رونق كبير في المعاملات التجارية وكانت تباع إلى أقصى بلاد المعمورة. "رأيت غنياً يملك من المال مئة وخمسين جملاً وله أربعون عبداً ومثلهم من الغلمان دخل عليّ غرفتي ليلةً في جزيرة (كيش) ولم يسترح طول الليل من كثر الهذر.فكان يقول: فلان شريكي بتركستان ولي بصناعة بهندستان وهذه البطاقة سند بأرض على فلان والشيء الفلاني بكفالة فلان وتارة كان يقول: إن السفر إلى الإسكندرية يملك عليّ فكري لأن جوّها لطيف ويقول: لا، لأن بحر المغرب مخوف وقال لي غير مرّة: يا سعدي ورائي سفر آخر فإذا انتهيت منه فسأجلس بزاوية اعتزالي بقية عمري وأترك التجارة فقلت: أي سفر ذلك؟ فقال: أريد أن أذهب بالكبريت الفارسي إلى الصين لأنني سمعت أنه هناك ذو قيمة عالية ومن هناك سأجلب الأقداح الصينية إلى بلاد الروم والديباج الرومي إلى الهند والفولاذ الهندي إلى حلب والمرايا الحلبية إلى اليمن والبرود اليمانية إلى فارس ومن بعد ذلك سأترك التجارة وأتخذ لي دكاناً أجلس فيه وظل يهذي هذيان المحموم بمثل هذه الأفكار الفاسدة ولمّا لم يبق بجعبته شيء من ذلك الهراء قال لي: يا سعدي حدثني أنت بما رأيت أو سمعت فقلت:
ويذكر سعدي أيضاً خاطرة أخرى عن مدينة حلب فيقول: "كنت مشوّش الخاطر من أصدقائي في دمشق فخرجت لصحراء القدس وأنست بالوحش فأسرت بيد الصليبيين وأجبروني على العمل في خندق طرابلس بالطين حتى رآني أحد تجار حلب الكبار على هذه الحال وكان لي معرفة به فتعجب ودفع غرامتي. أخذني معه إلى حلب وكانت له ابنة فعقد لي نكاحها بمئة دينار وبعد أن بنيت بها ظهر لي أنها سيئة الطبع مجبولة على العناء مخلوعة العنان سليطة اللسان، فنغصت على عيشي.. وذات مرة أطالت لي لسانها واستمرت تقول: أنت أنت ذاك اشتراك أب فأعتقك من قيد الفرنجة بعشرة دنانير فقلت: بلى هو الذي اشتراني بذلك المقدار ولكنه أوقعني بأسر يديك بمائة دينار..." ([10]) 6 ـ المثنوي المعنوي لجلال الدين محمد مولوي (604 ـ 5672. ق.) ولد ببلخ. كان والده أحد العلماء والصوفيين الكبار في زمنه. والده ـ بهاء الدين ـ هاجر مع أهل بيته إلى قونية حين كان جلال الدين طفلاً صغيراً. درس جلال تحصيله عند أبيه وبعد وفاته انضم لدروس برهان الدين المحقق الترمذي وإرشاداته. أرسل برهان الدين، مولوي لإكمال تعليمه ومعلوماته إلى حلب ودمشق حيث كانت من أكبر المراكز العلمية والأدبية في ذلك الزمان. كان أستاذه في الفقه والعلوم الدينية كمال الدين ابن العديم وبعد تحصيله العلمي في حلب لمدة ثلاث سنوات انتقل إلى دمشق وأقام سبع سنين وأفاض علماً ومعرفة.. أهم آثار مولوي نثراً وشعراً 1 ـ مثنوي المعنوي في 6 مجلدات ويشتمل 26 ألف بيت على بحر الرمل ويحتوي على حكايات منظومة يؤخذ منها عِبَرٌ دينية وعرفانية وتقدم الحقائق المعنوية بلغة بسيطة 2 ـ ديوان غزليات ويدعى بالديوان الكبير أو ديوان شمس يشتمل علي 50000 بيت 3 ـ الرباعيات 4 ـ المكتوبات 5 ـ فيه ما فيه 6 ـ المجالس السبعة. ترتبط دمشق وحلب بحياة مولوي ارتباطاً قوياً وقد ذكرهما في آثاره وأقام في دمشق في مدرسة المقدمية وقد عرّف الأستاذ محمد كرد علي في كتابه (خطط الشام) ذيل عنوان مدارس الحنفية بدمشق، مدرسة المقدمية ويقول: "إنه كان هناك مدرستين باسم المقدمية، المقدمية الجوانية والمقدمية البرانية. المقدمة الجوانية داخل باب العمارة إنشاء الأمير شمس الدين محمد بن المقدم في الأيام الصلاحية أنشئت سنة 575 وهي في حكم المفقود استصفي قسم منها وجعل دوراً وداخلها غرف تؤجر وحرمها مخزن، والمقدمية البرانية تجاه الركنية بسفح قاسيون شرقي الصالحية إنشاء فخر الدين إبراهيم بن المقدم، غير موجودة ولعلها دار الشريباني وحوض مائها لم يزل كما كان أمام حمام. ([11]) ويقول صاحب كتاب "الدارس في تاريخ المدارس" أيضاً: المدرسة المقدمية الجوانية داخل باب الفراديس الجديد. منشئها الأمير شمس الدين محمد بن المقدم في الأيام الصلاحية". ([12]) قضى مولوي عشر سنوات من عمره في بلاد الشام في البداية سنتان أو ثلاث في حلب في المدرسة الحلاوية وأفاد من وجود كمال الدين ابن العديم (المتوفي 660) وهو من العلماء والفقهاء الحنفيين المعروفين والمميزين في زمانه. وكان له مؤلفات عديدة وأقام سبع سنين في دمشق أيضاً وسكن المدرسة المقدمية الجوانية في الشام. وارتكب عبد الباقي كوليينارلي أحد المهتمين بمولوي والمحققين بشأنه باسم هذه المدرسة سماها المقدسية خطأ." ([13]) كانت كل من دمشق وحلب في هذا العهد من المراكز المهمة للعلوم الإسلامية ولجأ العديد من العلماء الإيرانيين إلى هذه النواحي بعد هجوم المغول وقضوا جل أوقاتهم في نشر العلم والعديد من العرفاء أقام في تلك النواحي لأن دمشق ونواحي جبل لبنان من الأمكنة المقدسة ومكان الأبدال والتجليات الغيبية وبوارقها. وكان يصلون ليلهم بنهارهم في جبل لبنان على أمل رؤية رجال الغيب كما أن الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي كان في الشام. والمدرسة الحلاوية التي درس فيها مولوي ثلاث سنوات كانت في البداية من الكنائس الرومية الكبيرة وكانوا يحبونها كثيراً بسبب قدمها والروايات الدينية القائلة بقدوم المسيح وحواريه إليها وإقامتهم فيها، ولأن الصليبين قاموا بالهجوم على حلب عام 518 قام المسلمون كرّد فعل عليهم بتحويل أربع كنائس كبيرة في حلب إلى مساجد وكانت من بينها تلك الكنيسة فأطلقوا عليها مسجد سراجين، بعد ذلك أضاف الملك نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالملك العادل عام 544 عدة حجرات وإيوان فأصبحت كمدرسة وقفها لأصحاب وأتباع أبي حنيفة وفي عام 634 قام عمر بن أحمد المعروف بابن العديم بتجديد عمارة هذه المدرسة وكان لديه هناك أوقاف كثيرة وعاش الطلاب بشكل مرفه وبفراغ بال هناك. مولوي في المجلد السادس من المثنوي في تشبيه المغفل الذي يضيع العمر وعند الموت في تلك الشدة أخذ في التوبة والاستغفار بقيام شيعة حلب بالتعزية كل سنة في أيام عاشوراء على بوابة أنطاكية، ووصف وصول شاعر غريب من السفر وسؤاله قائلاً: ما هذه الضجة أي تعزية؟ يقول: في يوم عاشوراء يكون كل أهل حلب على باب أنطاكية حتى الليل، يتجمع جمع عظيم من الرجال والنساء ويقيم مأتم تلك الأسرة من آل البيت ويصرخ الشيعة وينوحون باكين، في عاشوراء ذكرى كربلاء ويعددون ذلك الظلم والبلاء الذي لقيه آل البيت من شمر ويزيد. وتمضي صيحاتهم وتهديداتهم بالويل والثبور حتى تمتلئ بها الصحراء والوادي، فوصل شاعر غريب من الطريق يوم عاشوراء وسمع تلك الضجة. فترك المدينة واتجه إلى تلك الناحية بهدف البحث والتفتيش عن سرّ هذه الضجة. مضي متسائلاً بإمعان: ما هذا الحزن؟ وعلى من أقيم هذا المأتم؟ أهو رئيس عظيم ذلك الذي مات؟ إن مثل هذا التجمع لا يكون بالشيء الهيّن.. حدثوني عن اسمه وعن ألقابه، فأنا غريب وأنتم أهل هذه البلاد. ما اسمه؟ وما عمله وما هي أوصافه؟ حتى أنظم مرثية في مناقبة ولأنظم مرثية.. فقال له أحدهم.. ماذا؟ هل أنت بمجنون، ألا تعلم أن اليوم عاشوراء وهو مأتم لروح تفضل رجال قرن بأجمعهم. بالنسبة للمؤمن، متى يكون هذا الحزن هيناً... قال الشاعر: نعم.. لكن أين عهد يزيد؟ ومتى كان هذا الحزن؟ ولم وصل هذا متأخراً؟ إذن فأقيموا العزاء على أنفسكم أيها النائمون، ذلك أنه موت سيئ هذا النوم الثقيل. إنّ روح سلطان من السلاطين قد فرّت من السجن، فلماذا نمزّق الثياب؟ لماذا نعض البنان؟ ولماذا كان سيداً للدين يكون وقت سرور ذلك الوقت الذي كسر فيه القيد. لقد أسرع نحو سرادق الإقبال إنه يوم الملك والسرور والسلطان لو كان علمك بهم مثقال ذرّة. إن لم تكن عالماً فامض وابك على نفسك، ذلك أنّك منكر للانتقال والمحشر ونح علي قلبك ودينك الخربين. ([14]) جدير بالذكر أنّ لمولوي غزلاً جميلاً جدّاً في وصف دمشق فقد كرّر كلمة (دمشق) في جميع الأبيات كما أن وزن الغزل وزن مفرح لطيف. ويذكر فيه مناطق من دمشق كالخضراء وباب البريد والربوة وعين أبي نواس وباب الفرج وباب الفراديس والنيرب والمزّة والباب الشرقي والسويداء والصالحية وكما ذكر سابقاً أقام سبع سنين من عمره في طلب العلم في هذه البقعة.
(نحن عاشقو دمشق متيّمون والهون بها)
(منذ أن انفصلنا عن الحبيب أقمنا في باب البريد وجامع العشاق والخضراء)
(هل شربت ماءً من عين أبي نواس؟ نحن عاشقو تلك اليد السقاءة التي سقتنا من مائها العذب)
(أقسم بالقرآن أننا عشقنا دمشق أثر ذلك المعشوق كاللؤلؤ الساكن في دمشق)
(ابتعدت عن باب الفرج وباب الفراديس لا أحد يعلم لماذا استغرقنا في رؤية دمشق)
(نحن كالمسيح في المهد، نصعد الربوة وكالرهبان نعشق حمراء دمشق)
(رأينا شجرة عظيمة في النيرب فجلسنا في ظلالها وتهنا في حب دمشق)
(اخضرّ الميدان ونحن كالكرة تحركنا غرة الحبيب التي هي كالصولجان)
(لو دخلنا للمزّة والباب الشرقي وسويداء دمشق فلن يكون ذلك خاليا من اللطف)
(ولأن دمشق جنة الدنيا، نحن ما زلنا بانتظار رؤية جمال دمشق).
(في جبل الصالحية منجم للجواهر نحن غرقى بحر دمشق أثر ذلك المنجم)
(للمرّة الثالثة سوف نيمّم شطر الشام من قونية لأن عشق دمشق حرّك الأشواق فينا والدواعي)
(إذا كان سيدي شمس التبريزي في دمشق فسوف أبقى عاشقاً ومولهاً بدمشق) 7 ـ ظرايف وطرايف هذا الكتاب هو من تآليف الدكتور محمد آبادي باويل من المحققين والمؤلفين المعاصرين في إيران وقد درس هذا المؤلف خصوصيات كل مدينة من جهة شهرتها فقال بشأن مدينة حلب: "حلب مدينة كبيرة وقديمة وفيها قلعة ماثلة وكبيرة. فيها يوجد مقام سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ تبعد عن معرة النعمان 36 ميلاً. يقول ياقوت: ما رأيته من حلب وأعمالها جميعه يدل على أن الله تعالى اصطفاها وفضلها على كل المدن الأخرى وخلاصة الأمر أنه في أراضيها يتم زراعة القطن والسمسم والبطيخ الأصفر والخيار والتنباك والعنب والمشمس والتين والتفاح وكل هذا دون سقاية وتعطي أكلها بشكل ديمي. ويقول ناصر خسرو أيضاً: زراعتهم كلها حنطة وفيها الكثير من أشجار التين والزيتون والفستق واللوز والعنب فيها كثير وفستق حلب كان مشهوراً في الشرق الأوسط وبطيخ أيضاً. يقول المقدسي: منتجات مدينة حلب تشمل القطن والمنسوجات والأشنان والورد الأحمر وحلب أكثر شهرة في صناعة المرايا بين البلاد الشرقية. وعلى حد قول ناصر خسرو لا يوجد في كل أنحاء العالم صناعات زجاجية كالتي في حلب. هذا الرحالة الإيراني يقول: عندما يرد الإنسان إلى سوق الزجاج في حلب ينجذب لجمال أنواع الزجاج فيصبح قصد الخروج من السوق صعباً للغاية. والمصنوعات الزجاجية في حلب تصدر لجميع البلاد. وفي هذه المدينة تصنع أنواع من الأنابيب والأباريق والكؤوس الزجاجية الخاصة بالكيمائيين. يقول حمد الله المستوفي: جوهر الزجاج حجر الصوّان وأفضله موجود في حلب والمرايا الحلبية عريقة بالوصف ومشهورة جدّاً (نزهة القلوب، المقالة الثالثة)
(ديوان جامي، ص 716) (إذا كنت تسعى لكأس الدن وماء الخضر الأبدي، فاطلبه في الزجاج الحلبي وبنت العنب) اليوم أيضاً ثمة نوع من الألواح الحديدية الرقيقة المطلية بالزنك يصنعون منها السماور والأباريق رخيصة الثمن حيث يطلق عليها في إيران لفظ حلبي وسطح هذه الألواح المعدنية براق كالمرايا. الكرباس الحلبي ـ وهو نوع من القماش ـ مشهور كثيراً، حيث يقول فرخي السيستاني شاعر القرن الرابع هجري:
(ديوان فرخي، ص 325) نتائج البحث: 1 ـ كانت حلب محط أنظار الكتاب الإيرانيين الكبار على مرّ العصور. 2 ـ سافر الرحّالة والجغرافيّون والعلماء الإيرانيّون منذ الأزمان الغابرة وعبّر هؤلاء عن مشاهداتهم في هذه المدينة بمدوناتهم. 3 ـ إن ما يميز حلب منذ القدم مكانتها الاقتصادية في المنطقة وخصوصاً وجود أسواق ذات رونق كبير وصناعيين مهرة ومحلات صناعة الزجاج والمرايا. 4 ـ كانت الخصائص الثقافية لهذه المدينة مثل السكان والأقوام والأديان المختلفة والمدارس والمساجد والمعاهد الدينية والعلمية والقلعة وسورها القديم ومشاهد ومقامات عظمائها محمد أنظار زوّار هذه المدينة وموضع اهتمامهم. 5 ـ خلّدها الشعراء ممن زاروها بأشعارهم ووصفوها بأدقّ التعابير. 6 ـ وصف الرحّالة دمشق أيضاً بأحسن الأوصاف التي اشتركت بها مع حلب. المصادر: 1 ـ آثار البلاد وأخبار العباد، زكريا بن محمد قزويني، دار صادر، بيروت. (دون تاريخ). 2 ـ تاريخ كزيده، حمد الله مستوفي، تحقيق عبد الحسين نوائي، ط4، نشر اميركبير، تهران، 1381 ش. 3 ـ حدود العالم من المشرق إلى المغرب، تحقيق دكتر مريم ميراحمدي ودكتر غلام رضا وهرام، ط2، دانشكاه الزهرا، تهران، 1383ش. 4 ـ خطط الشام، محمد كرد علي، ط3، مكتبة النوري، دمشق، 1983م. 5 ـ الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، تحقيق جعفر الحسني، مكتبة الثقافة الدينية، دون مكان، (دون تاريخ). 6 ـ ديوان جامع شمس تبريزى، جلال الدين مولوى، فردوس، تهران، 1374ش. 7 ـ سفرنامه، ناصر خسرو، به كوشش دكتر محمد دبير سياقى، زوّار، تهران، 1356 ش. 8 ـ ظرايف وطرايف، دكتر محمد آبادى باويل، انجمن استادان زبان وأدبيات فارسى، تبريز، 1356 ش. 9 ـ فرهنك فارسي، دكتر محمد معين، ط10، أمير كبير، تهران، 1375ش. 10 ـ كلستان (روضة الورد)، سعدي شيرازي، ترجمة محمد الفراتي، دار طلاس، دمشق، (دون تاريخ). 11 ـ مثنوى معنوى ، جلال الدين مولويي، ترجمة الدكتور إبراهيم الدسوقي شتاء، دون مكان، 1966م. 12 ـ مولانا جلال الدين، زندكانى، فلسفه، آثار وكزيده اى از آنها، عبد الباقي كولبينارلى، ترجمه توفيق سبحانى، ط3، بزوهشكاه علوم انسانى ومطالعات فرهنكى، تهران، 1375ش. |
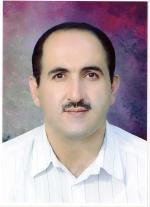 شهباز محسني
شهباز محسني